ملخص مختصـر محاضرات مادة علم الإجرام s5 pdf
محاضرات الفصل الخامس : دروس القانون الخاص S5
مادة علم الاجرام ترتكز على النظريات العلمية حسب الموضوع و حسب التوجه للاشارة عندما نقول التوجه يعني ان هناك اتجاه ينكب على دراسة المجرم و اتجاه آخر ينكب على دراسة الجريمة
مادة علم الاجرام ترتكز على النظريات العلمية حسب الموضوع و حسب التوجه للاشارة عندما نقول التوجه يعني ان هناك اتجاه ينكب على دراسة المجرم و اتجاه آخر ينكب على دراسة الجريمة
وهده المحاضرات موجهة الى طلبة السداسي الخامس وكذلك الطلبة الذين يستعدون لمباراة المحاماة في مادة علم الاجرام
تحميل تلخيص علم الاجرام PDF : اضغط هنا
اطلع ايضا على : تحميل ملخص كتاب مبادئ علم الاجرام والعقاب pdf
محاضرات في مادة علم الإجرام
الدكتور: بوحوص هشام أستاذ بكلية الحقوق بطنجة.
لما كان الخوف من الوقوع ضحية الجريمة، ظاهرة قديمة عاناها الإنسان في كل عصور البشرية ولا زال إلى اليوم يعانيها بل على قدر أكبر مما كان في الماضي، فقد اشتغل قادة الفكر وولاة الأمور في البشرية، بالبحث عن أسباب الإجرام على أمل التوصل إليها والقضاء عليها، وانبرى الفاحصون المدققون يدرسون أشخاص المجرمين وغير المجرمين سعيا وراء الكشف عن علامة عساها تنبئ حالة وجودها في إنسان ما بأنه مصدر للإجرام، دون أن يكون التوفيق حليفهم.
وكان الوقوع ضحية الإجرام ولا يزال شبيها بضريبة تفرضها الحياة على الأحياء، ولا يكف الناس مع ذلك عن السعي الحثيث في سبيل الخلاص منها أو الحد من وطئتها. فبذلوا سواء بأنفسهم أو عن طريق الدولة كممثل قانوني لهم، جهودا غير منقطعة ولا تزال متواصلة تنقيبا عن مصدر الإجرام فيمن يجرمون وعن الكيفية التي يتكون بها المجرم والتي على هدى منها يمكن رسم الكيفية التي يتقوم بها والتي يأمن بها المجتمع شر أمثاله كذلك.
لقد عرفت المجتمعات الإنسانية الجريمة وظلت ملازمة لها حتى وصفها بعض المتخصصين في علم الإجرام بأنها ظاهرة طبيعية، وأن ليس للإنسان منها مفرا إما بوصفه فاعلا لها أو مجنيا عليه. أو هي أمر واقع حتما كلما توفرت شروطها، شأنها في ذلك شأن بعض الظواهر الطبيعية الأخرى كغليان الماء أو تجلده إذا بلغت حرارته درجة معينة.
وها هو العالم الإيطالي أنريكو فيري يتأثر بالقوانين الطبيعية، فيصيغ في هذا المعنى قانونا أطلق عليه اسم قانون الكثافة الإجرامية، يتعين وفقا له وقوع نسبة من الإجرام لا تزيد ولا تنقص سواء رضي المجتمع بذلك أم لم يرض.
ولا يخفي القائلون بهذا الرأي تشاؤمهم المفرط إزاء ظاهرة الجريمة، الأمر الذي يجعل رأيهم محل نظر. فوصفهم للجريمة بأنها ظاهرة طبيعية يجافي واقع اليوم والأمس. فالجريمة مهما ارتفعت معدلاتها تعتبر ظاهرة استثنائية في حياة المجتمع، والدليل على ذلك حالة الرفض وردود الفعل المنظمة وغير المنظمة حيالها. ونعني بذلك استنكار ضمير المجتمع لها وكذا العقوبات المقررة لها.
ومن الذين اعتبروا الجريمة ظاهرة طبيعية إيميل دوركايم، بل هي في نظره حاجة ضرورية لتطور المجتمعات. وحجته في ذلك أن لا تقدم بلا حرية، وأن المجتمع الذي ينشد التطور ينبغي عليه أن يفسح لأفراده مجالا لحرية التصرف.
وفي هذا الإطار يسيء بعض الأفراد فهم الحرية، ومنهم من يسيء استغلالها ليرتكب الجريمة. وخلاصة هذا الرأي أن وقوع الجريمة في مجتمع ما، هو في تقدير دوركايم أمارة من أمارات تطوره، لأنه دليل على وجود قدر من الحرية فيه. أما إذا انقطع دابر الجريمة في مجتمع ما، فذاك أمر لا يمكن اعتباره على أي وجه بادرة صحة، بل هو علامة جمود، ودليل تصلب، ونذير فناء؛ ذلك أن اختفاء الجريمة يعني أن عوامل الضغط والقهر قد بلغت مداها، فأعدمت كل حركة، وقتلت كل فكرة، وكبلت الناس بالأغلال، وكتمت منهم الأنفاس.
وإذن فالجريمة في نهاية المطاف هي ثمن التطور الذي تحرزه الحضارة، فهي تضحية لازمة بجزء من تماسك المجتمع من أجل تطوره وارتقائه.
ويخلص عالم الاجتماع الأمريكي "سندرلاند" إلى النتيجة ذاتها عندما يوازن بين الأضرار المالية المترتبة على الجريمة وما يلزم من مبالغ مالية للقضاء عليها، وينتهي إلى القبول بها كأمر واقع بحكم ضخامة ما يجب إنفاقه سنويا للوصول إلى مجتمع بلا جريمة.
وقبل هؤلاء جميعا تعرض العالم العربي الفذ ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون إلى حالة التجمع وضرورتها لتقدم الحياة الإنسانية موضحا ما قد تفرزه الحياة المجتمعية من صراع وتناقض في المصالح بحكم النوازع الفردية لدى الأفراد، الأمر الذي يحتم وضع حدود لها من أجل استمرار الحياة المجتمعية.
فالمجرم والجريمة هو موضوع ذلك العلم الذي لا يزال إلى يومنا هذا آخذا طريقه إلى النمو والنضج والاكتمال، والذي يسمى في منهج كلية الحقوق بعلم الإجرام.
ومنذ أن بزغ فجر هذا العلم وكانت جذوره الأولى في فلسفة الإغريق حتى بلغ مرحلته الحالية من الكفاح في سبيل الحقيقة العلمية، تزداد أهميته يوما بعد يوم ولاسيما مع التزايد في موجة الإجرام.
والمتفحص لحقيقة الجريمة يجدها تمر دائما بمراحل ثلاث:
المرحلة الأولى: نشوء القاعدة السلوكية.
أولى تلك المراحل تبدأ عندما تلجأ الجماعة الإنسانية إلى وضع إطار عام لمجموعة من قواعد السلوك –التي نتعارف على تسميتها بالقواعد القانونية- التي يؤمل أن تسود بين أعضائها، وبموجبها تباعد الجماعة بينها وبين الفوضى واللانظام وتؤمن به مصالحها وقيمها التي تراها جديرة بالحماية، سياسية كانت هذه المصالح أو اقتصادية أو اجتماعية. ويوجب كل هذا أن تحدد الجماعة الإنسانية أجزية معينة توقع على من يخرج على إطار القواعد المنظمة للسلوك. عندئذ تتشكل القواعد التي توجه سلوك الأفراد نحو عمل أو الامتناع عن عمل ما من الأعمال
المرحلة الثانية: التقييم السلوكي.
يلي مرحلة نشوء القاعدة السلوكية، ومنها القواعد الضابطة للسلوك الفردي مع المصالح الجوهرية التي يحميها القانون الجنائي، المرحلة التي نسميها مرحلة التقييم السلوكي، إذ في ضوء القواعد التي رسمتها الجماعة تجري هذه الأخيرة من قبل سلطة عليا فيها مراجعة وتقييم لأنماط السلوك الفردية داخلها، كي تحدد في ضوء هذا التقييم ما يعد انتهاكا –ومن ثم يكون جريمة- للقواعد التي تحكم السلوك داخلها.
وبتعدد وذيوع عدم التكيف بين بعض أفراد الجماعة مع القواعد السلوكية الجنائية السائدة فيها، ومن ثم شيوع حالات الخروج الصريح على تلك الأخيرة في صورة الجريمة، تتشكل ما يعرف باسم الظاهرة الإجرامية، التي تقود في النهاية إلى تنوع الأمزجة وتفردها بين أعضاء الجماعة وتنوع ردود أفعال هؤلاء تجاه ما يتبناه المجتمع من أفراد ومعتقدات وفلسفات ساعدت على تشكيل الهيكل السياسي والاقتصادي والثقافي له.
المرحلة الثالثة: رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة.
من المنطقي ألا يقف المجتمع مكتوف الأيدي تجاه الانتهاكات الواقعة من بعض أفراد الجماعة للقواعد السلوكية السائدة، إذ لابد عليه أن يأخذ رد فعل مناسب متمثلا في أنواع من الجزاءات التي ترسمها الجماعة وتراها مناسبة ومتكافئة مع ما وقع من خروج صريح على نظامها الاجتماعي.
ولقد تطورت الجماعة الإنسانية في تحديد رد الفعل الذي تتخذه حيال التمرد على قواعدها. ففي المجتمعات القديمة، حيث لم تكن الدولة كتنظيم سياسي قد ظهرت بعد، كان يأخذ رد الفعل تجاه الجريمة شكلا من أشكال الانتقام، إلى أن طال المجتمعات التهذيب والتنظيم السياسي فصار لهذا الرد أطر قانونية وإنسانية تحد من وحشيته وقسوته، ولا تجعل من الإيلام الملازم للجزاء هدفا في ذاته، وإنما يرمي في النهاية إلى إعادة إصلاح وتأهيل من زل وهوى في دروب الجريمة.
ثانيا: الاتجاه إلى دراسة الظاهرة الاجرامية
لاشك أن محاولات تفسير الظاهرة الإجرامية كظاهرة فردية أو اجتماعية أمر يعود إلى أزمنة بعيدة. ففي الوقت الذي كانت فيه المجتمعات تقع تحت تأثيرات دينية مالت محاولات تفسير الظاهرة الإجرامية نحو إرجاعها إلى مخالفة أمر تمليه قوى مقدسة مجهولة تجعل من صاحبها "عاصيا" عليه واجب التكفير عن إثمه. وأن الإجرام ما هو إلا تقمص شيطاني بحق المجرم أو هو لعنة إلهية تحل بالإنسان لبعده عن الآلهة وعدم الطاعة والتقرب لها.
وقد ساد مثل هذا التطبيق لدى الإغريق قديما. فقد جاء على لسان الشاعر "سوفوكليس"، مؤلف التراجيديا الإغريقية "أوديب" قاتل أبيه وزوج أمه "إن أفعالي لم أرتكبها ولكن تحملتها". ولقد ظل هذا التفسير قائما لدى بعض التشريعات خلال القرن التاسع عشر –ومنها التشريع الإنجليزي- التي كانت توجب حال توجيه الاتهام إلى المجرم الإشارة إلى أنه لم يخالف القانون فقط بل إنه ترك نفسه للوساوس الشيطانية وأبعد نفسه عن الطاعة للأوامر الربانية.
ويستقر هذا التحليل بين العامة من بين أبناء الشعب االمغربي والعربي، ومع عودة الأصولية الدينية إلى رحاب البيئة العربية، والذين يميلون إلى إرجاع الجريمة، بل وكافة الأزمات، إلى غضب رباني، إذ أن المساحة الفاصلة بين العلم والدين ما تزال مجهولة لدى تلك الشعوب.
ولقد استمرت سيطرة التفسير الديني لكافة الأفعال الإنسانية وأنماط السلوك ومنه السلوك الإجرامي- خلال العصور الوسطى وإلى بداية العصور الحديثة خاصة مع بداية القرنين السابع عشر والثامن عشر ومع طغيان حركة الشغف العلمي التي سادت خلال هذه الحقبة الزمنية.
ولقد كانت البداية من خلال الربط بين الملامح الجسدية والتكوينية للشخص والميل نحو نمط إجرامي معين، كالربط بين حجم وشكل الجمجمة مثلا والجريمة، الأمر الذي يمثل أحد موضوعات ما يعرف بعلم الجماجم أو علم فراسة الدماغ، والذي ظهر على يد فرانسوا جوزيف جال العالم الفرنسي (1758-1828). أو الربط بين القامة أو نوع الشعر أو شكل العين وحجمها أو شكل اليد وبين الميل نحو شكل إجرامي معين.
وقد مهدت إلى هذا الربط دراسات العديد من العلماء من أمثال "ديلا بورتا" في مؤلفه "في الصفات الخلقية". وكذا "لافاتيه" (1801-1741) و"دي لاشامبر" و"فرانسوا جوزيف جال" (1828-1758) و"كورتس" والطبيب الفرنسي "بروكا" (1880-1824) الذي أسس في باريس عام 1865 جمعية علم الإنسان، والذين أرجعوا جميعهم الجريمة إلى خلل خلقي يعود إلى ضعف النمو الطبيعي للدماغ والمخ.
ولقد مهد لكل ظهور ما عرف باسم المدرسة الوضعية الإيطالية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، والتي تمثل البداية الحقيقية للدراسة العلمية المنهجية، وذلك على يد "سيزار لومبروزو" (1909-1836) حينما نشر مؤلفه الرجل المجرم في عام 1971، والذي أوضح فيه تميز المجرمين على خلاف أنماطهم بملامح وصفات جسدية وتكوينية تبعد عن تلك التي تلحظ لدى الباقين من الناس، مرجعا ذلك إلى ارتداد المجرم إلى الإنسان الأول أو البدائي.
وقد عمق هذه الدراسات وأضاف إليها بقية زعماء هذه المدرسة خاصة كل من "رفاييل جارو فالو" (1932-1852)، الذي يعود إليه الفضل في استخدام لفظ علم الإجرام الذي اتخذه عنوانا لإحدى مؤلفاته (1885)، و"أنريكو فيري" (1928-1856) الذي يعود إليه الفضل في تقسيم المجرمين إلى عدة طوائف: المجرمون بالميلاد، المجرمون المجانين، المجرمون المعتادون، المجرمون العرضيون، المجرمون العاطفيون. وإليه يعود الفضل كذلك في القول بقانون الإشباع والتشبع الإجرامي والذي مؤداه أن كل وسط يتضمن حتما قدرا من الإجرام. وأنه إذا ما تفاعلت العوامل الطبيعية مع عدد من الظروف الاجتماعية فإنه سوف ينتج عددا معينا من الجرائم دون زيادة أو نقص.
ومع بزوغ النصف الأول من القرن التاسع عشر تولد ما يعرف بالتفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية، بحسبانها ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة فردية، وذلك على أثر ظهور الإحصاءات الفرنسية الجنائية ابتداء من عام 1826، وكذا ذيوع منهج الفيلسوف الفرنسي "أوجست مونت" (1842-1803)، والذي عرض له مؤلفه المكون من ستة أجزاء تحت عنوان "دروس الفلسفة الوضعية"، والقائم على الملاحظة والتجريب والذي كان النواة الحقيقية لنشأة علم الاجتماع أو ما أطلق عليه كونت الطبيعة الاجتماعية.
ثالثا: مفهوم ونطاق علم الإجرام.
يكتنف علم الإجرام غموض شديد حول تحديد ماهيته، وقد يرجع ذلك إلى حداثة هذا العلم واتساع نطاقه وكذا تعدد موضوعاته، وإلى اتصاله بعلوم أخرى متنوعة يكون محل اهتمامها السلوك الإجرامي أيضا. كل هذا خلق شكلا من أشكال الاضطراب في مجال تعريف هذا العلم وتحديد نطاقه بين اتجاهين:
الاتجاه الموسع لنطاق علم الإجرام.
بعض علماء الاجرام اتجه إلى القول بأن تفسير الظاهرة الاجرامية لا يتحقق إلا بالاهتمام بفكرة الانحراف والسلوك الاجتماعي أو المضاد للمجتمع سواء شكل هذا السلوك جريمة وفقا للمفهوم القانوني لهذه الأخيرة أم لا. بمعنى توسعة مجال البحث في علم الإجرام لا ليشمل الجريمة بالمعنى القانوني الضيق فحسب ولكن ليشمل السلوك المنحرف في المجتمع ككل.
وعلى هذا عرف هذا الاتجاه علم الإجرام بكونه: العلم الذي يهتم بدراسته السلوك اللاجتماعي للإنسان بغية الوقوف على أسبابه وسبل علاجه.
ويلاحظ على هذا التعريف على أنه غامض وغير محدد ينطوي على تعريف واسع لمضمون علم الإجرام ويخلط بينه وبين علوم أخرى. وفي رأينا أن هذا التوسع في تعريف علم الإجرام أمر لا مبرر له حيث أن ذلك يؤدي إلى إدخال علوم أخرى تحت طيات هذا النوع من العلوم. مما يجعل من الظاهرة الإجرامية فكرة متشعبة لا تمكن باحثيها من التوصل إلى نتائج محددة.
الاتجاه المضيق لنطاق علم الإجرام.
يربط هذا الاتجاه علم الإجرام بالسلوك الإجرامي دون الانحراف بالمعنى الشامل أو السلوك اللاجتماعي المناهض لقيم وعادات المجتمع. وداخل هذا الاتجاه الضيق اختلف العلماء حول تحديد نطاق مهمة علم الإجرام بين فريقين:
الفريق الأول: الفريق الموسع لنطاق الإجرام
علم الإجرام ينطوي على شقين كبيرين يوصل أحدهما إلى الآخر:
الأول: شق سببي، يعني أن علم الإجرام هو علم من العلوم السببية الذي ينصرف إلى تحديد أسباب وعوامل الجريمة والظاهرة الإجرامية بحسبانها ظاهرة اجتماعية حتمية في حياة المجتمع وظاهرة احتمالية في حياة الفرد.
أما الشق الثاني: فهو الشق الوقائي والعلاجي أي دراسة الوسائل العلمية بهدف تحديد طرق وسبل الوقاية والمكافحة للجريمة من أجل الحد من الظاهرة الإجرامية، الأمر الذي قد يمد هذا العلم نحو ضرورة الإلمام ببعض المشكلات الاجتماعية المتصلة بالجريمة كإدمان العقاقير وأثر وسائل التكنولوجيا الحديثة على المجتمع والبطالة وعيوب النظام التعليمي. من أجل طرح السبل الكفيلة للحد من تلك المشكلات ومن ثم الحد من الظاهرة الإجرامية.
إذن علم الإجرام حسب هذا الاتجاه يهتم بشق تفسير الظاهرة الإجرامية، وبشق الوقاية والعلاج والمكافحة.
الفريق الثاني: المضيق لنطاق علم الإجرام.
أغلب علماء الجريمة –خاصة ممن يتبنون المفهوم القانوني في تعريف الجريمة، يقف بهذا العلم عند الشق الأول المتصل بتفسير الظاهرة الإجرامية، بمعنى قصر نطاق هذا العلم وهدفه على تحديد أسباب الظاهرة الإجرامية ودراسة بعض أنماطها دون أن يمتد الأمر إلى دراسته سبل مواجهتها، على اعتبار أن هذه رسالة يضطلع بها أفرع قانونية واجتماعية أخرى، كعلم السياسة الجنائية وعلم العقاب وعلم الوقاية العامة من الجريمة.
وهكذا يمكن أن نستخلص تعريفا مختصرا لهذا العلم: فرع من العلوم الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة المجتمع وحياة الفرد من أجل الكشف عن أسبابها وتحديد العوامل المهيأة والدافعة لها.
وإذا كان علم الإجرام يظهر بالتالي كعلم أسباب الظاهرة الإجرامية فإن هذا العلم يقسم إلى قسمين أو شقين:
علم الإجرام العام : يختص بدراسة علاقات السببية العامة التي تربط بين وقائع وظروف معينة وحجم وشكل الظاهرة الإجرامية. كدراسة الرابط بين عامل الفقر والمرض أو البطالة أو المهنة وبين السلوك الإجرامي لدى من توافر لديهم هذا العامل. ومن تم تحديد نسبة الاحتمال الذي يتوافر لعامل معين في الدفع إلى سلوك سبيل الجريمة أو الميل إلى نمط إجرامي معين.
علم الإجرام التطبيقي أو الكلينيكي : ينظر إلى الجريمة بحسبانها ظاهرة فردية تتنوع أسبابها وعواملها حسب كل حالة تحت الملاحظة.
ولعل مرجع قصور الدراسات الإجرامية هو تركيزها على فكرة العوامل في علم الإجرام العام، في حين أن الأوفق علميا هو البحث في العوامل الإجرامية التي تقف وراء كل نمط إجرامي معين (العلم الإجرامي التطبيقي)، فالتقدم في علم الطب لم يحدث إلا حينما انصرف العلماء عن دراسة أسباب المرض كظاهرة والتعمق في دراسة أسباب الأمراض على تنوعها. ويتوجب إذن للنهوض بالدراسات الإجرامية التعمق في دراسات علم الإجرام الفردي والأنماط الإجرامية. وحتى تلك اللحظة تسير الدراسة في إطار علم الإجرام العام الذي لا يتصل بجريمة بعينها أو بمجرم بعينه مما قد لا يمكن –وهو بالفعل لا يمكن- من استخلاص نظرية إجرامية واحدة تصلح لتفسير الظاهرة الإجرامية أو تحديد أهمية بعض العوامل الإجرامية.
لذا فمن الضروري أن تأخذ دراسات علم الإجرام منحى خاص يتركز على بعض أنماط السلوك الإجرامي وبعض أنماط المجرمين من أجل تحديد الملامح التي تستقل بها طائفة جرائم ونوعية مجرمين معينين. وهذا المنحى الخاص بالدراسات الإجرامية يمكننا من جعل تلك الأخيرة تخدم البيئة الوطنية وذلك من خلال تسليط الأضواء على ما يلمسه المجتمع ويستشري من أنماط إجرامية خاصة كالقتل والسرقة والجرائم الجنسية والإجرام المذهبي، أو طوائف خاصة من المجرمين كالمجرمين العائدين والمجرمين المحترفين والمجرمين بالمصادفة.
غير أن السؤال الذي يثور في هذا المجال ذو شقين:
الشق الأول: هل نحصر البحث في أسباب الظاهرة الإجرامية في مجال الجرائم الخلقية دون الجرائم المصطنعة أم أن البحث يجب أن يشمل المجالين معا؟.
الجرائم من حيث صلتها بالأخلاق قسمها "جارو فالو" إلى:
جرائم تتنافى مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع وهي ما يقال عنها بالجرائم الطبيعية، كالسرقة والقتل والنصب والتزوير والرشوة... وهي جرائم تعارفت جميع المجتمعات المتمدينة على تجريمها مهما تبدل الزمان والمكان، تتميز بالاستقرار والثبات.
وإما أنها لا تتعارض مع القيم الأخلاقية وهي ما يصطلح عليها بالجرائم المصطنعة كبعض الجرائم الجمركية أو الضريبية أو التموينية... وهي جرائم خلقها المشرع ذاته استجابة لاعتبارات تتعلق بتنظيم المجتمع وتطوره، وهي متنوعة من بلد لآخر وفي البلد الواحد من زمن لآخر.
ويذهب كثير من العلماء إلى إخراج هذه الجرائم الأخيرة من نطاق دراسات علم الإجرام مستندين إلى أن الباحث في هذا الميدان يهتم بالجرائم الخطيرة التي تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، فالمجرم في هذه الحالة فقط هو محور أبحاث علم الإجرام، التي تهدف إلى دراسة شخصيته وظروفه المختلفة لبيان الأسباب التي دفعته إلى الجريمة، أما في نطاق الجرائم المصطنعة حيث لا يقصد المشرع من ورائها سوى تحقيق أغراض تنظيمية، فهي تخرج عن نطاق الدراسات الإجرامية حيث أنها لا تفصح عن خطورة إجرامية لدى الجاني، ولا يسبب ارتكابها الاستنكار الاجتماعي الذي هو لصيق بالجرائم الطبيعية، ثم أنها أيضا جرائم غير ثابتة وإنما تخضع للتغيير المستمر من جانب الشارع.
بينما يذهب جانب آخر من الفقه إلى أن مجال الدراسات الإجرامية يجب أن يشمل النوعية معا –الجرائم الطبيعية والمصطنعة- ذلك أن مهمة الدراسات الإجرامية تنحصر في تحليل وتفسير السلوك الإجرامي في حد ذاته أيا كانت النتيجة التي تترتب عليه، فقد تتمثل تلك النتيجة في إلحاق الضرر ببعض المصالح، وقد يكون الضرر بسيطا أو جسيما، وقد لا يوجد ضرر على الإطلاق وإنما يكون التجريم نوعا من التجريم الوقائي حماية لمصلحة معينة من الخطر الذي يهددها، ولكن مخالفة هذه القواعد التشريعية عموما يدل على عدم تكيف الفرد مع المجتمع، ويفصح عن عدم الاكتراث بمصالح الآخرين أو المصلحة العامة، وهذا يقتضي دراسة ظروف الجاني المختلفة لبيان عوامل التكيف التي دفعته إلى الإقدام على ارتكاب المخالفات.
والواقع أن كلا الرأيين لا يخلو من صواب، ولكننا إلى الرأي الأول نميل، حيث أن ارتكاب الجرائم الطبيعية هو الذي يدل على خطورة إجرامية معينة، ويكشف عن خلل في شخصية الجاني أو في ظروفه يستوجب بحثه لمعرفة الأسباب الكامنة وراء سلوكه، ومثل هذه الجرائم هي التي تدعو إلى نوع من الاستنكار الاجتماعي لها، والانتقاص الاجتماعي من شخصية الفاعل، بعكس النوع الثاني من الجرائم، ورد الفعل الاجتماعي هذا يعتبر دليلا في حد ذاته يدل على شذوذ الطائفة الأولى من المجرمين دون الطائفة الثانية، وهو ما يرجع إلى حصر الدراسات الإجرامية في مرتكب الجرائم الطبيعية، دون الجرائم المصطنعة.
الشق الثاني: هل نحصر الدراسات الإجرامية في نطاق الجرائم كما يحددها المشرع أم أن هذه الدراسات يجب أن تمتد لتشمل الأفعال النافية للقيم الاجتماعية عموما حتى ولو لم يجرمها المشرع؟.
ذهب اتجاه بين العلماء إلى التوسع في مجال الدراسات الإجرامية ليشمل كل التصرفات التي تتعارض مع القيم السائدة في المجتمع حتى ولو لم يجرمها المشرع، على اعتبار أن مثل هذه التصرفات تسبب اختلالا في الحياة الاجتماعية، إما لخطورتها أو لكثرة انتشارها فلا يجوز تحديد مجال علم الإجرام بالجرائم كما ينص عليها المشرع وإلا وقف ذلك حائلا دون تقدم هذا العلم، فالطب العقلي ما كان يصل إلى ما وصل إليه لو قصر أبحاثه على الحالات العقلية التي تؤثر في المسؤولية الجنائية كما حددها القانون الجنائي.
وذهب رأي آخر إلى قصر نطاق الدراسات الإجرامية على مجال السلوك الإجرامي كما حدده المشرع في القانون الجنائي، واستبعاد السلوك الاجتماعي الآخر من نطاق هذه الدراسة، ذلك أن إدخال كافة أنماط السلوك الاجتماعي في نطاق الدراسات الإجرامية يتنافى مع الطبيعة العلمية لعلم الإجرام، والتي تتطلب أن يكون موضوع دراسة العلم محددا.
ونحن إلى الرأي الأول نميل، ذلك أن لعلم الإجرام هدفان محددان: الأول، المساعدة على تطوير التشريع الجنائي القائم وتطبيقه قضائيا وتنفيذيا. والثاني اكتشاف العوامل الإجرامية الكامنة في المجتمع وفي الأفراد تمهيدا لمحاربتها والوقاية من وقوع الجرائم.
رابعا: الأهمية العملية لعلم الإجرام
في نظر البعض علم الإجرام مادة غير قانونية تعتمد في دراستها على أبحاث يقوم بها أخصائيون من فنون أخرى غير فن القانون، كالطب أو علم النفس أو علم الاجتماع: فإذا أتينا بطبيب نفسي أو رجل اجتماع فإنه يستطيع أن يتحدث عن الدوافع النفسية أو العوامل الاجتماعية لارتكاب الجريمة خير مما يتحدث رجل القانون.
وهذا القول به بعض الصحة ولكنه لا يصح أن يقف حائلا دون رجل القانون وتأمل أسباب الظاهرة الإجرامية حتى وإن بدا أن دوره فيها هو دور الرجل الثاني أو الثالث. فالقانون الجنائي على خلاف غيره من القوانين مادته هو الإنسان ذاته، لأنه يصيب الإنسان في حياته أو في حريته أو في اعتباره. على خلاف القانون المدني مثلا الذي ينصب أساسا على الذمة المالية للإنسان.
وهذا السبب بذاته هو الذي يدفع رجل القانون الجنائي إلى دراسة علم الإجرام باعتباره يبحث في أسباب نشوء الظاهرة الإجرامية، لأنه إذا كانت فروع القانون الجنائي تعالج النصوص الجنائية فإن علم الإجرام يعالج الدوافع الفردية والاجتماعية لارتكاب الجريمة. ومثل هذه الدوافع لا يجب أن يغفل رجل القانون عن الإحاطة بها، بل وعن تأملها، لأنها تشكل بعدا ثالثا له، لن يستطيع أن يطبق النص الجنائي تطبيقا سليما إذا أغفله.
ذلك أن المشرع عندما يضع النصوص الجنائية، فإنه يضع في اعتباره التطبيق المرن لها، أي يجعل الجزاء فيها ذو حدين أدنى وأقصى، وعلى القاضي أن يطبق الجزاء الملائم لخطورة الفعل وخطورة الفاعل بين هذين الحدين، فمعرفة القاضي بالفاعل نفسيا واجتماعيا شرط لازم لسلامة النص الجنائي.
وعلم الإجرام هو الذي يقدم هذا البعد الثالث لرجل القانون الجنائي، فرجل القانون قد لا يستطيع أن يلم بالتكوين العضوي للإنسان كما يلم الطبيب، ولا أن يتحدث عن الخصائص النفسية كما يتحدث عالم النفس، ولا أن يتقصى الظروف الاجتماعية كما يفعل رجل الاجتماع، ولكنه بلا شك يستطيع أن يتأمل ما يدلي به كل هؤلاء ويطابقه على الواقع ثم يكون له رأيه في النهاية.
وتبدو أهمية علم الإجرام العملية في أكثر من ناحية، فهو أولا يسهم في علاج الجريمة بعد وقوعها، و من ناحية أخرى فهو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تفريد العقوبة تشريعا وقضاء وتنفيذا فدراسة الأسباب الفردية للجريمة، تؤدي إلى معرفة الأسباب التي أدت إلى اتجاه الجاني إلى سلوكه الإجرامي إلى حد ما، وذلك يدعو إلى محاولة المواءمة بين الجريمة وبين العقوبة، سواء عند وضع النص التشريعي، أو عند الحكم به من القضاء، أو عند تنفيذه من جهة التنفيذ.
خامسا: فروع علم الإجرام.
ويشمل علم الإجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعا له وهي علم طبائع المجرم –علم النفس الجنائي- علم الاجتماع الجنائي. ونتناولها فيما يلي:
علم طبائع المجرم: ويطلق عليه علم البيولوجيا الجنائية ويرجع الفضل في نشأته للإيطالي "لمبروزو" مؤسس المدرسة الوضعية الإيطالية. ويهتم هذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم من ناحية التكوين البدني أو الخارجي أو من حيث أجهزة الجسم الداخلية.
علم النفس الجنائي: يهتم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه لارتكاب الجريمة وتسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم. ويقوم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله الذهني لارتكاب الجريمة. ويستعين الباحث فيه بأساليب التحليل النفسي التي قال بها "فرويد" والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الاستعداد الذهني لارتكاب الجريمة.
يرى بعض الفقهاء أن علم النفس الجنائي هو جزء من علم البيولوجيا الجنائية أو علم طبائع المجرم باعتبار الأخير يتناول أيضا التكوين النفسي للمجرم وأنه من الصعب الفصل بين التكوين العضوي والتكوين النفسي للمجرم كما أن الصفات الجسمانية للشخص تؤثر على نفسيته وميله للإجرام.
علم الإجتماع الجنائي: يدرس هذا العلم العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي حيث يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد.



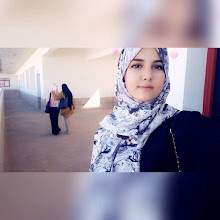

 0 التعليقات
0 التعليقات